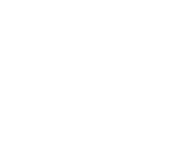الصبي الاعرج
” كلّ ذي عاهة جبّار“
بقلم الاديب الراحل توفيق يوسف عواد
كان اسمه خليل. ولكن الناس لا يعرفونه بهذا الاسم. هم يسمّونه الأعرج، حتّى كاد ينسى هو نفسه اسمه الحقيقي.
ولا أحد يعرف من أبوه وأمه وأين مسكنه. نكرة من النكرات، شحّاد من ملاعين الدنيا، قذفته الحياة قذفاً، كالماّر على رصيف يبصق بصقة ثم يدوسها ويتابع الطريق.
في الثالثة عشرة من عمره، على وجهه بقع من الغبار المزمن، وأخاديد من الذلّ. يجرّ، طول النهار وقسماً كبيراً من الليل، رجله العوجاء من مكان الى مكان. الرجل اليمين مفتولة عند الركبة الى الوراء يدوس بها الأرض على ابهامه، والابهام صخمة شققّها المشي على الحصى، وعشّش بين شقوقها وحل الشتاء الماضي.
كلّما خطا خطوة اندفع رأسه الى الأمام وراء العرجة اندفاعة تكاد تخلع رأسه من بين كتفيه. وهو مضطّر الى الدوران في الشوارع، من شارع الى شارع، ومن دكّان الى دكّان، من رجل الى رجل، ومن امرأة الى امرأة، ويمدّ كفّه ويبتسم ابتسامته الباكية.
رفاقه الشحّادون، صغاراً وكباراً، لكّل واحد منهم أغنية يردّدها على المحسنين. يطلبون من اللّه أن يطّول لهم عمرهم، أن يخلّي لهم عافيتهم ، أن يعوّض عليهم، أن يرزق المرأة ولداً والفتاة عريساً، وأن يكافئهم خيراً في الآخرة. يثرثرون دائماً، ويلصقون بالمحسنين لصقاً، فلا ينزعهم الاّ القرش.
أما هو فلا يجيد الثرثرة بل يبقى صامتاً كالأخرس. لولا ابتسامته الحزينة، ولولا عيناه الناطقتان بألف لغز ولغز من ألغاز الطفولة المقهورة، ولولا يده الممتدّة، الراجفة، الممصوصة كورقة الخريف، لولا ذلك لظنّه الناس صنماً.
والبشر يحبّون الثرثرة، يحبّون الدعاء، لا يعطون الصدقة الاّ بثمنها عدّاً ونقداً. ولكن الأعرج لا تتحرك له شفتان بدعاء ولا رجاء، كأنما في قلبه ايمان بأن له على هؤلاء البشر ضريبة. يمدّ كفّه الى واحد، ثمّ يجوز الى غيره جارّاً رجله العوجاء. واذا ظفر بقرش أو نصف قرش حدّق اليه وقلّبه ثم وضعه في جيب قمبازه القذر المرقّع، ومشى.
* * * *
في حي فرن الشبّاك، على مسافة ربع ساعة من مشية خليل العرجاء، كوخ حقير جدرانه من أخشاب صناديق الكاز، وماركات الشركات ما تزال محفورة عليها بالأحمر والأزرق والأسود، بعضها محفوظ سالم، والبعض الآخر أكلت ثلاثة أرباعه السنون. وللكوخ سقف من تنك الكاز أيضاً، وللتنكات قهقهة ساخرة عندما تهبّ الرياح، وبينها ثقوب ينزل فيها المطر فيحوّل الكوخ في الشتاء الى مستنقع.
هذه القطرات من المطر هي كلّ ما تذكر به السماء ساكني الكوخ !
لأن الأعرج ليس وحده فيه، بل هو تحت حماية العمّ ابراهيم. شحّاد متقاعد، بين الخمسين والخامسة والخمسين من عمره، كسيح، مقصوف الظهر، ملتوي الذقن الى الشمال، بارز الأسنان – كتلة من الخرق والعظام المحطّمة ملقاة في زاوية الكوخ.
كان الليل قد أظلم، وأقفرت طريق فرن الشبّاك الاّ من بعض التراموايات ينعس فيها ركّابها القليلون، وتمرّ على الخطّ مسرعة، محدثة عليه شرراً متطايراً وأزيزا ًموجعاً. وكان الأعرج يمشي على حافة الطريق مسروراً ببساط الغبار لا يؤذي رجله العوجاء التي تتلقّى وطأة جسمه دون الأخرى. كلّما تقدّم ضاعف قلبه دقّاته، لأن العمّ ابراهيم رجل قاس لا يعرف الرحمة، يحب أن ترجع يده من يد الأعرج بخمسين قرشاً كلّ مساء. وكان الصبي يحسب القروش التي جمعها طول نهاره فلا تبلغ الاّ سبعة وعشرين قرشاً، فيزيد خوفه وترتعد فرائصه.
وأبى الأعرج أن يصدّق حساب النهار الذي كان قد قام به أكثر من عشر مرّات. فلمّا وصل تحت المصباح الكهربائي المعلّق على المحطّة الأخيرة من محطّات الترامواي أخرج القروش من جيبه وأخذ يعدّها مرة أخرى، فاذا هي سبعة وعشرون قرشاً، لم تزد شيئاً قط ! فأعادها الى مكانها وهو يرفّ بعينيه وقد همّتا بالبكاء، وواصل مشيته ببطء كأنّه يقدّم رجلاً ويؤخّر الثانية.
كان عليه أن يصل. استقبله العمّ ابراهيم، حسب العادة. وراء قنديل الزيت الضئيل المتماوجة أظلاله على جدران الكوخ، قائلاً :
- تعال هنا، هات الحساب !
كان العمّ ابراهيم على طرّاحته في الزاوية، مسمّرا عليها، لا يستطيع حراكاً الاّ بيديه فهما له رجلان
أيضاً. فحمل الأعرج القنديل وجاء به فركع أمام الطرّاحة، وأخذ يعدّ القروش واحداً وراء واحد، ويفتش في قعر جيبه وينفضها ليؤخّر غضب العمّ ابراهيم. ولكّن العمّ ابراهيم كان واقفاً على كلّ حركة وسكنة من الصبي، فأرسل اليه نظرة من عينيه الحمراوين الملتهبتين وصاح به :
- سبعة وعشرون قرشاً من أوّل النهار الى آخره ! أنت تلعب كلّ الوقت يا أعرج اللعون. لك ثلاث عشرون عصاً. حساب مضبوط.
وكشّر، ولوى ذقنه الى الشمال فوق ما لواه اللّه، ولبث منتظراً الأعرج. كان الأعرج يعرف ما يجب عمله في مثل هذه الحال : كلّ قرش ينقص عن الخمسين بعصاً. والعصا معلّقة في الحائط. فنهض من ركعته ودنا من الحائط، وجاء بالعصا فسلّمها الى العمّ ابراهيم ووقف أمامه مكتوف اليدين. فرفع الجلاد عصاه السوداء السمينة، وطفق يضرب بها الأعرج ضرباً له نظام : ضربة على الكتف اليمنى، وثانية على اليسرى، وأخرى على القفا، ورابعة وخامسة على الرجل العوجاء. والأعرج يعدّ العصي بصوت عال : واحد، اثنان، ثلاثة…خمسة…تسعة، وهو يخنق الصراخ خنقاً. فاذا صرخ ضوعف له العقاب. والدموع تسيل على خدّيه، وخدّاه يتجعدّان، وعيناه تتواريان وراء صور الألم المرتسمة على وجهه، وفمه يندلق، ودمه يفور في أوداجه ويوشك أن يفتّقها تفتيقاً.
وهو ما يزال في الضربة العاشرة من الحساب ! وعبثاً كان يحاول اقناع عمّه بأن الناس لا يدفعون. عبثاً كان يقول له انّهم يعطونه كسر الخبز… انّ العمّ ابراهيم كان يجيبه :
- اضرب بالرغيف من يعطيك ايّاه على وجهه !
* * * *
ذات يوم رجع الأعرج الى الكوخ مطروداً من الشوارع بمفاجأة عظيمة : كانت الحكومة قد سنّت قانوناً يمنع التسوّل ! فلقيه شرطي وصفقه بالسوط على قفاه، فلم توجعه الضربة لأنه معتاد أشدّ منها من عصا العمّ ابرهيم، ولكّن الوجع كان في نفسه.
ممنوع ! ممنوع مدّ الأيدي من الآن وصاعداً ! ممنوع طرق الأبواب، وايقاف المّارة، والدعاء بطول الأعمار.
لماذا ؟
سؤال هائل ارتسم على وجه الأعرج الصغير، لا يعرف له جواباً. كلّ ما كان يعرف من هذه الحياة أنّ عليه الرجوع كلّ مساء بخمسين قرشاً يسلّمها الى العمّ ابراهيم. أفاق على نفسه على هذا الشكل من الحياة. وعلى الرغم من العذاب الذي يلاقيه فهو يتمنّى أن تدوم الحال على ما هي. وها هي لا تريد أن تدوم. ها هو يرجع الى الكوخ بقرشين اثنين. ها هو ذاهب لثمان وأربعين عصاً تسلخ جلده… وغداً، وبعد غد خمسون عصاً ! كلّ يوم خمسون عصاً ! يا اللّه، هذا شيء كثير !
هذه المرّة قعد الأعرج على حافة الطريق يبكي ويشهق، والناس يمّرون مشاة، وفي السيّارات والتراموايات، لا أحد يلتفت اليه أو يسمع نحيبه… جثة قطّ أو قشرة ليمون !
على أن العمّ ابراهيم كان مطّلعاً على كلّ شيء. ولمّا عاد الصبي الى الكوخ سامحه بالثماني والأربعين عصاً. وشدّ ما كانت دهشته عندما أدناه اليه وأمسك برأسه ومسح جبينه بشاربيه… ولم يكتف بذلك بل قدّم اليه عشاءه بيده : علبة سردين – كلّها له – ورغيفاً. ثمّ ربّت على كتفه وقال له :
- ستكون بعد اليوم تاجراً، كما تريد الحكومة. وقهقه عالياً. أمّا هو فلم يفهم وظلّ مشدوها
مسروراً لأن العصا باقية في مكانها معّلقة. وكان لا يجسر على النظر اليها، بل يجوّل وجهه عنها لئلا يذكّر العمّ ابراهيم أنّها هنا !
وأصبح الأعرج تاجراً. لقّنه العمّ ابراهيم كلّ شيء. اشترى له صندوقة ودلّه على دكّان حلويات في حيّ الناصرة، وأوصاه أن يملأ من الدكّان كلّ صباح صندوقته هذه بقطع الكاتو، ويدور في المدينة تاجراً.
وكانت الصندوقة تستوعب أربع دزّينات : ثماني وأربعين قطعة. يشتري الواحدة بقرش ونصف، ويبعها بقرشين ونصف.
ارتاح الأعرج الى شكل حياته الجديد بادىء ذي بدء، وحمل الصندوقة على خصره مربوطة الى عنقه بحزام من جلد لمّاع، وأخذ يدور في الشوارع منادياً بصوته الضعيف : كاتو ! كاتو !
ولكن العمّ ابراهيم أوصاه بوجوب بيع الثماني والأربعين قطعة كلّها. ولمّا انقضى نصف النهار ورأى الأعرج أنّه لم يبع الاّ سبع قطع حطّ صندوقته على رصيف شارع المعرض وأحسّ بحاجة جديدة الى البكاء. ماذا يقول له العمّ ابراهيم اذا بقي شيء من الكاتو ؟ أتكون كلّ قطعة باقية بعصاً ؟ يا ليت ! انّ القرش من زمان، اذا نقص، كان بعصاً. وثمن كلّ قطعة قرش ونصف… هذا اذا حاسبه العمّ ابراهيم على سعر الشراء، أمّا سعر البيع ؟ !
على أنّ القدر كان يخبّىء للأعرج – لبصقة الحياة على الرصيف – أشدّ ممّا كان يتوقّع. فلمّا أظلم الليل، وهمّ بالرجوع الى الكوخ، دنا منه وراء المدرسة اللعازارية، في ذلك الطريق الموحش، ثلاثة صبيان، الكبير فيهم من سنّه. وما كاد يراهم مقبلين نحوه حتّى ارتعد، كأن الهاماً نزل عليه بأنّهم يريدون به شراً. وكانوا يغّنون ويلّوحون بأيديهم في الفضاء، وزعيمهم ذو القمباز الطويل ينفخ بأنفه كالحيوان.
وقف الأعرج على رجله الصحيحة، وأدار وجه صندوقته الى حائط المدرسة، وانتظر. فتقدّم الزعيم ونظر يميناً وشمالاً، ولمّا تيقّن من أنّ أحداً لا يراه صفع التاجر الصغير على وجهه صفعة طاش لها دماغه في رأسه، وهجم الثلاثة على الصندوقة، فنهبوا أكثر ما فيها وأطلقوا سيقانهم للريح، يزدردون الحلويات ويقهقهون.
وحينما عاد الأعرج في المساء الى الكوخ نال نصيبه أربعاً وثلاثين عصاً : حساباً مضبوطاً على سعر البيع… كما حدّثه قلبه في الطريق.
اسودّت الدنيا في عينيه. لأن الرواية كانت تتكرّر كلّ يوم، وصبيان الشوارع المشرّدون في بيروت كثيرون ينازعون الكلب على عظمته، فكيف بقطع الكاتو اللذيذة !… ما يكاد يراهم عن بعد حتّى يأخذ في الركض. ويالها من ركضة على رجله العوجاء ! رأسه ينخلع على صدره، وصندوقته ترقص على خصره، والحلويات يختلط بعضها ببعض وتتحطّم وتسيل، وتصير أشبه ما يكون بالوحل.
ذات يوم أطبق الغلمان الأشرار عليه في حيّ الكراويا وأخذوا يشدّون بشعره، وأمسكه أحدهم برجله – أيّاها – يدقّها بحجر ويسخر منه :
- يا أعرج ! يا أعرج !
واذا بصائح يصيح بهم مهدّداً فيهربون كلّ واحد الى صوب. فرفع الأعرج وجهه عن التراب متفقدّاً صندوقته، فاذا به أمام كريم الحلواني صاحب الدكّان الذي يتبضّع من عنده كلّ صباح. أحسّ بقلبه يكبر، ومسح دموعه، ونفض ثيابه من الغبار وقال :
- كلّ يوم يلحقون بي ويضربونني ويأكلون الحلويات.
وقام الى الصندوقة يتناولها، ويلتقط الحلويات عن الأرض وقد تبعثرت هنا وهناك ولبست ثوباً من الأقذار. فقال له كريم عاقداً أجفانه :
- أتركها ، سأعطيك غيرها.
فرفع اليه الأعرج عينين كأنّهما تسألان : ولكن ثمنها ؟ فقال له كريم :
- قم. ما عليك. أعطيك أربع دزّينات كاملة ولا آخذ منك قرشاً. وسأعّلمك كيف تتغلّب على هؤلاء الزعران.
كان كريم من القبضايات المشهورين في الحي – يقال انّ في عنقه ثلاثة قتلى – وأبناء الحي يتناقلون أخباره، ويهابون جانبه، ويشدّون أنفسهم بظهره الملمّات.
وبالرغم من تقدّمه في السنّ – خمسون سنة وأكثر – كان لا يزال محمّر الوجه بالعافية، لامع العينين بالبطولة، معقوف الشاربين بأناقة واباء. الاّ أنّه كان قد ترك منذ زمان كار المراجل وانقطع الى تجارته.
سار الأعرج وراء كريم الى محطّة اليسوعية، الى الترامواي. كانت تلك المّرة الأولى التي يركب فيها الأعرج الترامواي. لذلك كاد ينسى مصيبته في التفرّج على مقاعد الحافلة، وعلى قاطع التذاكر يدور بينها، وعلى التذكرة التي قطعها له. وكان يحسّ أن هذه الدرجة التي صعدها من الأرض الى الترامواي قد نقلته من دنيا الى دنيا.
ولمّا ترجّل كريم على محطّة الناصرة قاد الأعرج بيده الى الدكّان، وأدخله الى القسم الخلفي منه وقال له :
- ألا تعرف البوكس ؟
- لا !
- اجمع كفّك اليمنى.
- ها !
فتناول كريم كفّه وسوّاها له وقال :
- اذا جاء اليك الأولاد مرىة أخرى فاجمع كفّك هكذا واضربهم. وصوّب الضربة الى الذقن أو الأنف أو
الخصر. اضربن لأرى !
فصعّد الأعرج الى كريم نظرة حبية كأنه يقول : كيف أضربك ؟
- اضرب، اضرب ولا تخف !
فجمع الأعرج كفّه وهمّ، ولكنّ كريم تلقّى الضربة بيده وقال له :
- عليك أن تتمرّن. اذهب الى هذا الكيس واعمل فيه البوكس !
وكان هناك كيس مملؤ بالفحم، فأخذ الأعرج يوسعه ضرباً بيديه حتىّ اسودّتا وكلتّا. حينئذ قام كريم
اليه وربّت على كتفه قائلاً :
– تأتي كلّ يوم الى هنا وتتمرّن. وبعد أسبوع ستغلب أكبر أزعر في السوق.
شعر الأعرج بأن أعجوبة من السماء أرسلت اليه هذا المنقذ، فشرع يتردّد عليه. وفي الصباح، حين يأتي ليملأ صندوقته، يمكث عنده ساعة ويذهب الى كيس الفحم ويتمرّن على البوكس بفرح يغمر قلبه، فتلمع عيناه، خلال غبار الفحم المتطاير، لمعاناً بساماً.
وقد يحدث أن تتخدّش كفّاه ويسيل منهما الدم، فلا يحفل ويستمّر في اللكم، وكريم أمامه يدّخن سيكارته مزهواً :
- لمّا كنت في عمرك كنت أكسّر أكبر رأس في رفاقي، وكانت الناصرة من أوّلها الى آخرها تقول : فلان !
فينظر اليه الأعرج ويبلع بريقه متسائلاً : متى أصير هكذا ؟
وتوثّقت العلاقة بين الصديقين على تباعد السنّ. ولكن الصبي لم يبح لكريم بالسرّ الذي يؤلّف مأساة حياته. لم يقل له أنّ عمّه يضربه كلّ يوم بلا شفقة. بل كان يقول، تحت سحر العبودية، وحسب ما أوصاه عمّه، انّه يحنو عليه حنّو الوالد على ولده.
ولمّا سأله كريم عن أبيه وأمه قال :
- لا أعرفهما. يقول لي عمي انّهما تركاني طفلاً. أتعرفهما أنت ؟
ابتسم كريم وأجاب هازاً رأسه :
- كلاّ، يا ابني، لا أعرفهما.
* * * *
ذات مساء تأخّر الأعرج في سوق المعرض. كان لا يزال في صندوقته ثلاث قطع . فأخذ يطوف بها من رصيف الى رصيف، بين أخلاط الناس المزدحمين في السوق، منادياً : كاتو ! كاتو !
واذا بثلاثة غلمان حفاة، مبعثري الشعور، بارزي الصدور من شقوق قمصانهم المهلهلة، يهجمون عليه وقد عرفوه. فتراجع الى جدار وأسند ظهره اليه ووضع الصندوقة الى جانبه، وشمّر عن ساعديه، ونفخ بمنخريه وصاح بهم :
- تعالوا ! اقتربوا من هنا !
فقهقه الصبيان هزءًا. أما هو الأعرج نفسه ؟ أما هو الذي يسلبونه كلّ يوم ويشبعونه ضرباً بعد أن يشبعوا من كاتوياته ؟ ها ! ها ! ها ! ها !… ودنا زعيمهم ذو القنباز المشقوق بين الفخذين. دنا ببطء، برباطة جأش، وهمّ بادخال يده في الصندوقة. فما كان من الأعرج الاّ أن جمع كفّه اليمنى وأمسك باليسرى ناصية خصمه ثمّ ضربه بوكساً على يافوخه فانطرح تحته على الأرض. وقد سبق رأسه رجليه. فهجم الآخران، فأثبت الأعرج رجله الصحيحة على بلاط الرصيف وانهال عليهما، لهذا ضربة على أنفه، ولذاك ضربة على خصيتيه – كما علّمه كريم – وأعاد الكرّة، فلم يلبثوا أن تفّرقوا وهو ينظر اليهم ولا يصدّق !
حينئذ رفع أنفه في الفضاء، ولبث دقيقة طويلة سكران بالظفر، جامداً، الاّ دمه يفور في أعصابه ويتمشّى في جسمه من أمّ رأسه الى أخمص قدميه. دم جديد قويّ، كأنّ اللّه خلق الأعرج خلقة ثانية.
ثمّ انحنى على الصندوقة فتناول قطعة كاتو. ثمّ تناول الثانية والثالثة، والتهمها واحدة وراء واحدة، يكافىء نفسه. ومشى يبحث عن الغلمان يميناً وشمالاً، وخلفاً وقدّاماً، ليريهم كيف تؤخذ الثارات !
* * * *
اللّه من شتاء بيروت ! تنصبّ الأمطار ساعات دون انقطاع، كأنّ اللّه يفتح أبواب السماء ثمّ ينسى اقفالها !
وقد مضى موعد الرجوع الى الكوخ، والأعرج ينتظر على ساحة البرج قابعاً تحت رفرف دكّان، والسيّارات تمرّ براكبيها ملفّعين بالثياب الصوفية الدافئة، وترسل اليه رشاش الوحول – شتائم الغنى الى الفقر ! – فتصبغ وجهه وتنفذ الى قطع الحلوى الباقية في صندوقته.
أخيراً ملّ الانتظار وحدّثته نفسه، سرّاً، بالصعود الى الترامواي الذي جاء فوقف على المحطّة بالقرب منه. وكان لم يركبه الأّ مرة واحدة حينما أنقذه كريم من الصبيان المتآمرين عليه.
نهض، وحمل صندوقته، وقدّم رجله العوجاء. ولكنه عاد ففكّر بعمّه ابراهيم. يجب أن يعطيه الحساب مضبوطاً. واذا نقص ماذا يقول له ؟ أيقول له انّه ركب الترامواي ؟ وأوشك الأعرج أن يضحك من نفسه. وسار الترامواي مسرعاً، وهو يرافقه بعينيه حتّى توارى عنه في المنعطف. ثمّ اقشعّر بدنه من البرد، ووصلت القشعريرة الى رجليه الحافيتين، فأخذ ينظر اليهما وقد غسل المطر منهما جانباً، وأحدث في الجانب الآخر سواقي صغيرة.
وجاء الترامواي الثاني، فتمتم الأعرج بشتيمة متحدّياً الكون ! وصعد شادّاً صندوقته تحت ابطه. ولكنّ قاطع التذاكر ما كاد يراه في قذارته حتّى دفعه دفعة، فوقع في الشارع، وجاء رأسه في بركة وسخة، ودخل الماء الى فمه وأذنيه، ومرّت سيّارة مستعجلة على صندوقته فحطّمتها شرّ تحطيم
ومرّ الترامواي بأزيزه، ومرّت السيّارة بهديرها، وقام الأعرج كتلة من الأسمال والأوحال… ولكنّه لم يبك. لم يحسّ بالألم. مسح وجهه بطرف قمبازه، ورفس أشلاء الصندوقة برجله العوجاء، ومشى.
هذه المرّة، رأى العمّ ابراهيم من الأعرج ما لم يكن له به عهد. فجنّ جنونه وانكبّ عليه بالعصا بضربه دون نظام أينما جاءت الضربة، ودون حساب على قروش ولا قطع كاتو. ولم يعدّ الأعرج العصي وقد تجاوزت العدّ. وظلّ تحت الضرب لا يتجعّد له وجه، ولا تنزل له دمعة. مع أنّ العصا جاءت على عينه اليسرى وأورمتها فثقلت كقطعة من رصاص.
واعترف الصبي بكلّ شيء: بأنّه ركب الترامواي، وحطّمت السّيارة صندوقته، وأكل ثلاث قطع كاتو. وسيأكل كلّ يوم مثلها وأكثر ! حتّى مزّق العمّ ابراهيم ثيابه، وودّ لو يستطيع نهش هذا الأعرج الملعون بأسنانه.
وكان العمّ ابراهيم يسبّ الخالق لأنّه بلاه بالمرض، وهو يزحف في الكوخ على قفاه، غارزاً يديه في الأرض ، لاحقاً بالأعرج من جانب الى جانب، كالقطّة وراء فأرة صغيرة. حتّى تعب أخيراً واستلقى في زاويته…
* * * *
مرّت ساعة، ساعتان، والأعرج لا يغمض له جفن. وأبى تلك الليلة أن يطفىء القنديل. كان ينظر على ضوئه الشاحب الى أقسام الكوخ كأنّه يتعرّف اليه لأوّل مرّة. ثمّ سمع غطيطاً فرفع رأسه… كان العمّ ابراهيم غارقاً في النوم، والضوء يتماوج على حاجبيه الكثيفين، ولحيته الكثّة، وأنفه الطويل، وشاربيه المسترخيين، وذقنه الملتوي. ورأى فمه مفتوحاً, منفرج الشفتين.
وكأنّ انفراجهما حفّز الأعرج، فأزاح الغطاء وركع على فراشه يريد الوقوف… يريد الهرب… بل يريد الانقضاض على هذا العمّ الوحش بالبوكس – كما علّمه كريم – وبالعصا المعلّقة هنا. العصا التي مضى عليها سنون وهي تأكل من جلده ولا تشبع ! هذه العصا نفسها يجب أن ترتدّ على الذي تعّود حملها عليه : على قفاه، وذراعيه، وكتفيه، ويافوخه.
وانّ الأعرج ليهمّ، اذا بالعمّ ابراهيم يوقف غطيطه فجأة وينقلب على جنبه. فصعق الصبي في مكانه، وخيل اليه أنّ عمّه مطّلع على ما يجول في دماغه، وأنّه يفتح عينيه، وأنّ العصا تترك الحائط من تلقاء نفسها وتمشي اليه في فراشه…
_ يا أعرج الملعون !
يا أعرج الملعون ! سمع الأعرج الصرخة تطنّ في أذنيه فانحلّت عزيمته – عاد الى ثيابه العبد – وأرخى نفسه.
حينئذ دخل من شقوق الكوخ برق هائل ملأه، ثم قصف الرعد قصفات متتابعة، مزمجرة، بعثت في جسمه رعشة مثّلجة، فوطّن نفسه على النوم. ولكنّ عينيه وقعتا فجأة على صورة رأس الهندي – ماركة احدى شركات الكاز – فوق رأس العمّ ابراهيم. صورة ما تزال على احدى خشبات الكوخ جديدة، بارزة، كأنّها محفورة منذ يومين، والريش النافر يحيط بذلك الرأس هالة مخيفة. فلبث الأعرج محدّقاً اليها على ضوء القنديل المتمايل فوق أمتعة الكوخ العيقة وعلى حيطانه، ثمّ قال في نفسه : ” كم هو قويّ هذا الهندي !”
وقام على الأثر من فراشه كالآلة، لا يخاف ولا يفكّر بشيء. ذهب توّاً الى العصا المعّلقة فوق رأس عمّه وتناولها بيده، وقبضها جيداً، ثمّ أخذ ينظر الى شاربي العمّ ابراهيم يصعدان ويهبطان، ويصغي الى غطيطه يشتّد ويخفت. ثمّ كشّر عن أسنانه كابن النمر، ورفع العصا الى فوق، بكلتا يديه، وانهال على وجه العمّ ابراهيم : على شاربيه ضربة، وأتبعها بالثانية والثالثة على الجبين والذقن، قبل أن يستطيع عمّه صياحاً. ولمّا أفاق العمّ ابراهيم عاجله الأعرج بضربة رابعة وخامسة وسادسة… دون حساب أيضا.
وكان العمّ ابراهيم يعوي تحت العصي المتراكمة عليه عواء الكلب أصابه الصيّاد خطأ، ويتململ، ويجدّف، ويحاول النهوض، ولكن عبثاً. انّه كسيح. وكان يلحق زاحفاً بالأعرج من زاوية الى زاوية لعلّه ينتزع العصا منه، فيناوله حاملها الضربة على يده، وعلى رأسه، وعلى بطنه، فيشتدّ عواؤه، ويختلط بعصفات الرعد في الخارج وقهقهات تنكات الكاز على سطح الكوخ في تلك الليلة الليلاء.
وحدث أنّ العصا لطمت القنديل بينما كان الأعرج يرفعها على العمّ ابراهيم متراجعاً من أمامه، فتحطّمت بقايا زجاجته، وانقلب القنديل على الفراش فاندلق زيته، فهّبت النار دفعة واحدة ، ونشرت في الكوخ المظلم ضوءاً كبيراً. فكان الأعرج أسرع من بروق تلك الليلة. ركض الى الباب وفتحه وخرج، ثمّ حاول اغلاقه، فاذا بالعمّ ابراهيم يهرب من الحريق ويهجم على الباب فيمسكه من حافته , وهو يصرخ مستغيثاً، لأنّ الكوخ كان قد تحّول الى أتون. وأخذ الصبي يشدّ من جهة، وعمّه يشدّ من جهة، ثمّ انحنى الأعرج على اليدين الضخمتين الممسكتين بحافّة الباب، وعضّهما عضّة ذاق بها طعم الدم، فارتختا، فأقفل الباب بالمفتاح جيداً، وابتعد عن النار وكان لهيبها قد وصل اليه، ودخانها في أنفه.
وكان بالقرب من الكوخ شجرة من الأزدرخت قديمة العهد، فوقف تحتها يتّقي المطر المتساقط، وينظر الى الكوخ تتداعى جدرانه، وتندلع منه ألسنة النيران، وتنقضّ تنكات الكاز بعضها فوق بعض بقرقعة شديدة
وأرهف الأعرج أذنيه ليسمع صوت العمّ ابراهيم. فاذا صوت مثل خوار البقر بدأ قوياً… قوياً… ثمّ أخذ يضعف شيئاً فشيئاً، ثمّ عاد الى الخوار أقوى منه قبلاً، ثمّ هوى الكوخ هوياً واحداً، محدثاً ضجّة ارتعدت لها فرائص الأعرج بالرغم من شجاعته وهول ما كان يحسّ به من نشوة الانتقام.
حينئذ مشى الى الشارع، وهو يرسل بين الخطوة والخطوة نظرة الى الوراء ونظرة الى الأمام, أما الكوخ فقد صار رماداً بمن فيه… الاّ بعض جمرات تطفئها الأمطار على مهل.
وامّا الشارع فمعفر، ليس فيه الاّ ظلّ الأعرج يلقيه المصباح الكهربائي المعّلق على محطة الترامواي.
ظلّ طويل، مستقيم، كلّما تقدّم الأعرج في المشي زاد في طوله واستقامته، واختفت منه العرجة… حتى خيّل اليه أنّ أوّله عند رجله العوجاء، وآخره معلّق بتلك النجمة المرتجفة التي انقشعت عنها الغيوم في أفق السماء
الأديب توفيق يوسف عواد
ولد الأديب توفيق يوسف عواد في بحرصاف، وهي قرية عريقة من قضاء المتن في جبل لبنان وذلك سنة 1911 في 28 تشرين الثاني. بدأ دراسته تحت سنديانة دير ماريوسف بحرصاف، ثم في مدرس سيدة المعونات في ساقية المسك فمدرسة سيدة النجاة في بكفيا حيث نال الشهادة الابتدائية. واستبد به ميله إلى الأدب مذ ذاك، فكان يقضي الليالي في قراءة الكتب-عربية وفرنسية، ولا يحلم إلا بأن يكون في مستقبله كاتباً وشاعراً. أرسله أبوه إلى بيروت وأدخله كلية القديس يوسف للآباء اليسيوعيين، وأثناء دراسته الثانوية فيها برزت مواهبه بروزاً لفت الأنظار، كان أبوه يعدّه للمحاماة، ولكنه أعرض عن هذه الرغبة وراح يكتب في الصحف نثراً وشعراً، نشر في مجلة “العرائس” سلسلة مقالات نقدية حمل فيها على أدب التقليد، وألقى محاضرات في ذلك، داعياً إلى التجديد في أساليب التفكير والتعبير.
وفي العام 1928 ألقى محاضرة عن الشعر العامي، الزجل، عرض فيه لتاريخه وتقاليده ومزاياه، وقد نشرت هذه المحاضرة في مجلة “المشرق” وأصبحت مذ ذاك مرجعاً لدارسي هذا الفن. بدأ الأديب توفيق يوسف عواد ممارسته للصحافة في جريدة “البرق” لصاحبها بشارة الخوري “الأخطل الصغير”، وفي دارها تعرف إلى خليل مطران شاعر القطرين، وإلياس أبو شبكة، وإبراهيم طوقان وغيرهم، وفي العام 1932 نشر في “البرق” سلسلة مقالات عن ميخائيل نعيمة العائد من نيويورك بعنوان “ناسك الشخروب”. وقد غلب هذا اللعب على نعيمة منذ ذلك الحين.
وكان لتوفيق يوسف عواد إسهاماً كبيراً في الحركة الأدبية التي قامت بها مجلة “المكشوف” في الثلاثينات بمقالات دورية وقصائد وقصص، وكان من أركان هذه الحركة البارزين تأليفاً وتوجيهاً. نشر قصته “الصبي الأعرج” حلقة أولى من سلسلة منشرات “المكشوف” فحياه ميخائيل نعيمة في رسالة نقدية بقوله: “يخيل إليّ أنك ما تعلمت الكتابة إلا لتكتب القصة”، وأتبع عواد قصته هذه في 1937 بقصة: “قميص الصوف” وفي 1939 برائعته “الرغيف”. فلاقت كلها رواجاً منقطع النظير، وكرسه النقاد العرب والمستشرقون على أثر ذلك رائداً لهذا النوع الأدبي، ودخلت كتب هذه، وما تلاها في برامج الدراسة وأصبحت مادة تثقيفية للناشئة جيلاً بعد جيل.
وقد تنقل الأديب توفيق يوسف عواد في مناصب دبلوماسية كثيرة كان فيها سفيراً لبلاده في الدول الأوروبية انقطع في فترة منها عن التأليف إلا أنه عاد في العام 1962 إلى عطاءاته الأدبية بإصداره حوارية “السائح والترجمان”، فنالت جائزة “أصدقاء الكتاب” لأحسن مسرحية، كتب بعدها سلسلة خواطر يومية في جريدة “الحياة” بعنوان “فنجان قهوة” “عبيده”، نحا فيها النحو الذي اتبعه من قبل في “نهاريات”. ونشر في العام 1963 “فرسان الكلام” وهو نظرات في الأدب والأدباء، بالإضافة إلى “غبار الأيام”، وهو مجموعة خواطر مستوحاة من الحياة اليومية. وكتب في العام 1969، وكان حينها سفيراً لبلاده في اليابان روايته “طواحين بيروت”، ومجموعة قصصه الرابعة “مطار الصقيع” ولكن الرواية لم تنشر إلا في 1973، وكذلك المجموعة القصصية لم تنشر غلا في العام 1982. أصدر ديوانه “قوافل الزمان” أو قصائد البيتين في عام 1973 وفي العام 1974 اختارته منظمة الأونيسكو في لائحة “الكتاب العالميين الأكثر تمثيلاً لعصرهم”. استقر في أواخر حياته في بيته في بحرصاف ونشر في العام 1983 “حصاد العمر”، وهو عمل أدبي سطّر فيه سيرته الذاتي، متّبعاً فيه أسلوباً فريداً بناه على الحوار الذاتي، وفي عمله هذا لم يكتف الأديب بوصف مراحل سيرته، بل هو تعدّى ذلك إلى اعترافات حميمة تكشف عن كل شيء في حياته الخاصة والعامة… حياة مليئة وقفها على الحب بمعناه الإنساني الرحيب، متغنياً بهذا الحب، نثراً وشعراً، بكل جوارحه.
وفي نهاية المطاف يمكن القول بأن أدب عواد امتاز بالعمق والشمول، وذلك في نثره وشعره، كما أنه امتاز بحرارة التعبير وصدقه، وكان أسلوبه السردي، من السهل الممتنع، مع قوة في الإيحاء أضفت على كتاباته جواً أخاذاً بعيد لمرامي. وهو في وصفه لإنسان القرية وإنسان المدينة، في قصصه ورواياته، يصور الإنسان في كل مكان. نرى أبطاله في وجوه الناس من حولنا، نعايشهم في أفراحهم، ونشاطرهم صراعهم مع القدر. من هنا كان لأدب توفيق يوسف عواد تأثيره البالغ وقيمته الباقية عبر الأجيال.
توفي عام 1988 اثر سقوط قذيفة على بيته خلال الحرب الأهلية اللبنانية . صنفت روايته طواحين بيروت واحد من افضل مائة رواية عربية
منقول